بين الاقتصاد والسياسة | صعود اليمين وأزمة العولمة

المقال مترجم عن مجلة The economist حيث نشر عليها في فبراير 2016
يشهد الوقت الراهن صراعًا يخوضه القادة السياسيون ومسؤولو المصارف المركزية ورجال الاقتصاد بسبب عدد من المشكلات، في الوقت الذي تنازعهم الأحزاب الشعبية على مراكز السلطة، بعد أن ارتأت أن النموذج الاقتصادي الحالي عديم الجدوى، بل إنها تقول إن السياسات التي تنتهجها الحكومات تخدم مصالح الفئات الحاكمة أكثر من خدمتها للناخبين.
إن المتأمل في تاريخ الاقتصاد ربما يجده ترجمة حيّة لحكمة قديمة تقول: “من يدفع للعازف يختار المعزوفة”. فمن بيده القرار الاقتصادي إذن؟
يُفضِل رجالُ السياسة عادةً مجاراة الأمور لضمان الحفاظ على مناصبهم، ولا يتبنون من الأفكار الاقتصادية إلا ما يَصُبُّ في مصلحتهم الشخصية. حيث تنحاز القرارات السياسية للجماعات بقدر نفوذها الاقتصادي. وأبرز الأدلة على ذلك ما حدث في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من استحواذ الطبقات الوسطى ثم عمال المصانع على الأصوات. أما رجال الاقتصاد في المقابل، فيحاولون جاهدين التغلب على المشكلات الأكثر ارتباطًا بالمجتمعات التي يعيشون بها، ولكنهم سيتعاملون معها من منظور هيكل النفوذ السياسي.
وفقًا للمدرسة الكلاسيكية التي كانت مسيطرة في القرن التاسع عشر، فإن الوضع الاقتصادي يميل للاستقرار (التوازن) من تلقاء نفسه (وبالتالي فلا توجد حاجة لتدخل الحكومة في الاقتصاد)، وقد جاء هذا الطرح مناسبًا للفئة السياسية المهيمنة على الساحة من الدائنين الأثرياء الذين يرجون ألا تلعب الحكومة أي دور فعّال، إذ يعني ذلك فرض ضرائب كبيرة عليهم. إن مصالحهم تكمن في الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لأموالهم، وهو ما بدا جليًّا في استخدام الغطاء الذهبي (كنظام نقدي) وفي الاستعانة بالمصارف المركزية لحماية النظام المالي، وهو الأمر الوحيد الذي كان التدخل الرسمي للدولة في الاقتصاد فيه خيارًا مرغوبًا.
كانت أمريكا هي الدولة المستثناة من هذا الوضع، إذ لم يؤسَس نظام الاحتياطي الفيدرالي إلا في عام 1913. لكن النظام السياسي الأمريكي كان أكثر ديمقراطية من نظيره الأوروبي. فمع اقتصار حق الانتخاب في مختلف الدول على الرجال، حرصت أمريكا على تقديم دعمٍ قويٍ لحرية إنشاء البنوك الخاصة؛ الأمر الذي أتاح للمزارعين سهولة الحصول على القروض. في الوقت الذي نَعِم فيه القادة السياسيون الأوربيون بقدرٍ أقلٍ من الحرية الديمقراطية مما دفعهم إلى مزيد من الاهتمام بحقوق الدائنين.
جاءت الحرب العالمية الثانية لتهدم هذا النظام الاقتصادي القديم بما خلّفته من تدخلٍ فادحٍ للحكومات في الاقتصاد؛ فرض الضرائب الباهظة، الديون، والتضخم. كما باءت محاولات إصلاح ذلك النظام في عشرينيات القرن الماضي بالفشل نتيجة الكساد الكبير، حيث لم تكن الحكومات الديمقراطية مستعدة لوضع العمال في الظروف القاسية التي يتطلبها تطبيق الغطاء الذهبي.
بالإضافة إلى ما سبق، أجبر الكسادُ رجالَ الاقتصاد على التعامل مع مشكلة جديدة؛ وهي عدم قدرة الاقتصاد على استرجاع التشغيل الكامل، فبادر “كينز” باستحداث نظريةً لتفعيل دور الإنفاق الحكومي في زيادة الطلب الكلي. وقد لقيت نظريته قبولًا واسعًا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي شهدت تدخلًا متزايدًا للحكومات في الاقتصاد، حيث تركزت جهود الإدارات الاقتصادية بشكل أساسي على خفض معدل البطالة. وارتأت النخب السياسية حينها إقامة دول الرفاهية* كثمن بسيط لعرقلة قدوم الاشتراكية.
*دول الرفاهية؛ هو مصطلح يطلَق على الدول التي تلعب فيها الحكومات دورًا كبيرًا في حماية وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها.
الركود التضخمي وثورة الطبقة الوسطى
إن ارتفاع معدل التضخم في العقدين السادس والسابع من القرن العشرين أدى إلى تغيير جديد في الفكر الاقتصادي. ففي الماضي، بدا أن ظاهرتي التضخم والبطالة تظهران في الاقتصاد بشكل متناوب حيث تُطلّ إحداهما برأسها بينما تتوارى الأخرى. إلا أن فترة الركود التضخمي (وهي الفترة التي امتدت بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي) أثبتت أنهما قد يرتفعان معًا في الوقت نفسه. لقد رأت الموجة الجديدة من رجال الاقتصاد، وفي مقدمتهم ميلتون فريدمان، أن الحكومات تبذل الكثير من الجهود التي تذهب سُدى، وأنها يجب أن تركز على خفض معدل التضخم بالسيطرة على العرض النقدي. فبدلًا من محاولة إنعاش الاقتصاد بالسياسة المالية، ينبغي للحكومات التركيز على “جانب العرض” من خلال تشجيع النمو بخفض الضرائب واستئصال أوجه القصور والإجراءات العقيمة، ونعبر عن هذه السياسة باسم “الإصلاح الهيكلي”.
لقد حازت هذه المبادرة السياسية دعم الطبقة الوسطى التي كانت ساخطة لارتفاع الضرائب ويساورها القلق بشأن نمو التوجه العدائي للنقابات العمالية. وجاءت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على رأس الدول التي غيرت سياستها الاقتصادية في عهد رونالد ريجان ومارجريت ثاتشر، لكن أوروبا لم تحوّل سياساتها إلا بعد تصاعد المخاوف من بُطء النمو الاقتصادي، أو ما عُرف حينها باسم “التصلب الأوروبي”.
قد يعزز الإصلاح الهيكلي النمو على المدى الطويل لكنه لا يفيد كثيرًا في إدارة التحولات المفاجئة للدورة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تحوّل التركيز إلى السياسة النقدية مما أدى إلى ظهور المصارف المركزية التي عُرفت بالنشاط والاستقلالية التمجيد المبالغ فيه لـآلان جرينسبان Alan Greenspan )الاقتصادي الأمريكي الذي شغل منصب محافظ الاحتياطي الفدرالي في الفترة بين 1987 و2006) ورفاقه.
تزامن هذا التحول مع تراجع نسب التضخم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (ومن ثَمّ ذاع صيت المسؤولين في المصارف المركزية لدورهم في هذا الإنجاز، رغم أن الفضل الأكبر قد يرجع إلى بزوغ نجم الصين في سماء الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تدابير لمقاومة التضخم). وأثمر التحول الاقتصادي عن تراجع ضخم في عوائد السندات وارتفاع كبير في أسعار الأسهم. في الوقت ذاته، ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي قدّمها كل من ريجان وثاتشر في تحرير القطاع المالي، مما أدى إلى توسع كبير في ممارساته (على سبيل المثال: ظهور قطاعيَّ صناديق التحوط hedge funds والأسهم الخاصة private equities) وزيادة الأجور مقارنةً ببقية القطاعات الاقتصادية وارتفاع كبير في الديون مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي على مستوى القطاع الخاص.
لقد أدى ارتفاع معدلات الديون إلى إحاطة النظام الاقتصادي بالمخاطر وتشجيع المصارف المركزية على خفض معدلات الفائدة عند تقلب أوضاع الأسواق، وهذا ما صار جليًّا عام 1987 عندما أقدمت المصارف المركزية، بمبادرةٍ من جرينسبان، على خفض معدلات الفائدة بعد الاثنين الأسود (الذي شهد أكبر هبوط يومي لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 23%). وأثناء ما بدا من اعتزام المصارف المركزية خفض قيمة أسعار الأصول، استطاع البعض تكوين الثروات باستخدام أبسط الطرق: شراء الأصول (لا سيّما العقارات) عن طريق الاقتراض.
وعلى الجانب الآخر، صار القطاع المالي أقوى من ذي قبل مع توقف العمل بأسعار الصرف الثابتة وإلغاء الرقابة على حرية تنقل رؤوس الأموال. بالشكل الذي يمكنها من إحداث أضرار اقتصادية كبيرة بدخولها وخروجها من الأنظمة الاقتصادية والقطاعات المختلفة. ليصبح تخفيف حركة رؤوس الأموال في صدارة أولويات الحكومة. وفي الوقت ذاته، تمكّن القطاع المالي بفضل ثروته من تمويل النخبة السياسية وتحريض رجال السياسة على تأييد السياسات التي تصب في مصالحهم. وبالطبع كان للقناعة السائدة بحكمة ملاك الثروات (والتي تقضي بأنه إذا كنت غنيا، فذلك بسبب ذكائك بالطبع) فضل في تشجيع أصحاب الثروات على اقتحام معترك السياسة.
خلال الحقبة الاقتصادية التي امتدت من عام 1980 تقريبًا وحتى عام 2007، اتجه المناخ السياسي صوب اليمين، وبدأ السياسيون اليساريون في تكييف أوضاعهم لتناسب النظام الجديد. وكما قَبِل سياسيو اليمين دولة الرفاهية بعد عام 1945 كوسيلة للتخلص من خطر الاشتراكية، قَبِل رجال اليسار سياسات السوق الحرة الجيدة كطريقة لتمويل البرامج الاجتماعية التي يرغبون في تنفيذها. فإذا لم يكن انهيار الاتحاد السوفيتي يعني “نهاية التاريخ” فهو يعكس تحولًا حاسمًا في الفكر الاقتصادي والسياسي.
لقد تراجعت أعداد المنضمين إلى النقابات العمالية في كثير من الدول كما تراجع عدد الإضرابات كذلك. ويمكن أن يُعزى هذا إلى أسباب كثيرة، من بينها: العولمة، وقدرة الشركات على تحويل إنتاجها إلى المجالات الأقل تكلفة، وتراجع نصيب القطاع الصناعي من مستوى الناتج الاقتصادي وفرص التوظيف. فكما اتسع نفوذ النقابات مع ظهور الإنتاج الصناعي في المصانع، تأثر هذا النفوذ سلبيًا عندما أغلقت المصانع أبوابها. لقد كان من الصعب تنظيم العمال المشتتين في المتاجر والمكاتب ومراكز الاتصالات وتحفيزهم.
وبهذه الطريقة، أدى تراجع النفوذ الاقتصادي للناخبين من طبقة العمال إلى تراجع نفوذهم السياسي، كما انحسر الاهتمام بالعملية الديمقراطية وانخفضت أعداد من يدلون بأصواتهم من 80% إلى 70% في الدول الديمقراطية الغربية. ومن الواضح أن المصارف المركزية كانت أقوى الأركان التي قام عليها الاقتصاد الحديث، باعتبارها مثالًا صارخًا للمؤسسات غير الديمقراطية.
وعلى مدار تلك الفترة الطويلة، تشعّبت اهتمامات علم الاقتصاد كثيرًا مع التركيز على مواضيع الاقتصاد الجزئي والتأكيد على أهمية النماذج النظرية والدقة الحسابية (وهذا بالطبع وجه من التعميم، فقد شهدنا أيضًا ظهور علم الاقتصاد السلوكي، إضافة إلى إسهامات “هايمن مينسكي” Hyman Minsky التي ركزت على تهديد الاستقرار الاقتصادي كسمة طبيعية للدين).
أزمة الدين وما بعدها
لا شك أن أزمة الدين التي حدثت عامي 2007 و2008 تُعَدُ نقطة تحول مهمة في الفكر الاقتصادي والسياسي، تمامًا كما كان الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي. فما زلنا نعاني حتى اليوم من آثارها. لكن ظهرت بعض المشكلات الأخرى. صار ينبغي لقطاعيِّ الديون والتمويل أن يضطلعا بدورٍ أكثر أهمية في تصميم نماذج الاقتصادي الكلي. إن الدين ليس مجرد لعبة اقتصادية تضمن ربح طرف مقابل خسارة آخر، والتمويل ليس مجرد قناة لتداول الأموال لكنه قد يُشَكِّلُ خطرًا جسيمًا على الاستقرار، ويمكن أن تفقد التركيز على القيم الأساسية.
سيضطر رجال الاقتصاد أيضًا إلى مجابهة المشكلات الكبرى التي تسببت في صعود القوى الشعبوية إلى الساحة الاقتصادية بعد الأزمة. لماذا عانى عامل الطبقة الوسطى من ركود دخله بتلك الصورة؟ هل استأثرت النخبة (في الدول المتقدمة على الأقل) بحصد ثمار العولمة؟ ما الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بتحرير حركة رأس المال والعمالة وكيف يجري توزيعها؟ هل غياب التكافؤ يُعدّ النتيجة الوحيدة لما يطلق عليه “التحوّل التقني القائم على المهارات” (ويُقصد بذلك تفضيل الموظفين الأعلى تعليمًا لإدارة التقنيات الحديثة)؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما أثر التحوّل التقني القادم (أتمتة العمل المكتبي والسيارات ذاتية القيادة)؟
وإذا لم تكن التكنولوجيا هي السبب، فهل يُحتمل وجود صلة بين زيادة عدم التكافؤ والعوامل الهيكلية داخل الدولة (الأنشطة الريعية لكبار المموّلين كمثال)؟ كيف يؤثر تقدم سن السكان في دول العالم المتقدمة على النمو الاقتصادي وأجور العمال من صغار السن (مع قلة أعدادهم مقارنةً بالحاجة إليهم)؟ هل يُسهِم التحول التقني في مسيرة النمو كما حدث سابقا ؟ كيف سيؤثر الدين على كل هذه القضايا؟ حتى الآن، لم يأتِ مثل كينز وفريدمان ليعيد صياغة النظرية الاقتصادية بما يوفر إجابات لجميع التساؤلات السابقة أو حتى أكثرها.
عندما يتعلق الأمر بتداخل الاقتصاد والسياسة، تكمن القضية الكبرى فيما إذا كانت الحركة الشعبوية ستُخِلُّ فعلًا بموازين القوى، فأنصار تلك الحركة يرفضون الكثير من مظاهر العولمة ويناهضون تحرير حركة رأس المال والعمالة والبضائع (في بعض الحالات) نظرًا لتأثيرها على جمهور الناخبين. يخاف الموظفون من استبدالهم بالمهاجرين والموظفين الأقل أجورًا في آسيا؛ لذا فإن المشاركين في الحملات ضد التقشف ينددون بتقليص الإنفاق الذي دعت إليه الحاجة لجلب رضا الأسواق (أو الدائنين الخارجيين).
إن المشكلة هنا تتلخص في أن فكرة الاقتصاد العالمي صارت حقيقة بالفعل، وبات الناخبون يتأثرون بما يقع خارج حدود بلادهم؛ فازدهار الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين يتوقف على قدرة السلطات الصينية على إدارة نظامهم المالي وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مخطئًا في قرار إيقاف التحفيز النقدي، وليس بوسع فرانسوا أولاند وأنجيلا ميركل وديفيد كاميرون (أو هيلاري كلينتون وتيد كروز وماركو روبي) فعل الكثير حيال ذلك.
يحتاج رجال السياسة إلى إطلاق الحملات في بلادهم، وقطع وعود قد تحول الظروف العالمية دون الوفاء بها. وفي هذا الإطار، ساهمت العولمة في الفصل بين السلطة السياسية والنفوذ الاقتصادي وجعلت الناخب العادي يشعر بمزيد من خيبة الأمل وبالتالي المزيد من السخط إلى جانب ذلك، قد تؤدي النزعة القومية التي تشوب الحركة الشعبية إلى استحداث سياسات التسول من دول الجوار، تلك السياسات التي سادت في ثلاثينيات القرن الماضي وتذكرنا بقرارات دونالد ترامب بفرض تعريفة قدرها 45% على البضائع الصينية. إن دولتيّ فنزويلا والأرجنتين يضربان مثلًا على مدى الضرر الاقتصادي الذي قد تُحدثه الحركة الشعبية. وبالإضافة إلى هذا، أخفقت الحلول المقترحة لبعض مشاكل الاقتصاد بفعل المعارضة الشعبية؛ فالدول التي زادت معدلات الهجرة منها تميزت بتحسن الأوضاع الديموغرافية لكن (بعض) الناخبين يرفضون قرار الهجرة رفضًا قاطعًا لاعتبارات ثقافية جنبًا إلى جنب مع الاعتبارات الاقتصادية.
وعلى المستوى المحلي، كيف يتماشى ظهور القوى الشعبوية مع الطرح القائل بأن النفوذ السياسي تابع للنفوذ الاقتصادي؟ هل ينبغي للأثرياء منع تلك القوى من النجاح؟ حسنًا، قد يكون هذا هو الحال بالفعل، إذ اقتصر نفوذ القوى الشعبوية حتى الآن على أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، لكنها برزت على الساحة بفضل مقوّمات ربما يكون الإنترنت أحدها. إن حشد العقول المتوافقة أمر هيّن، كما أنه من الممكن خلق الوعي لدى المواطنين بالقضايا الشعبية التي قد لا يتطرق إليها رفقاؤهم في العمل أو أفراد عائلاتهم.
إن نسبة التصويت التي نجحت القوى الشعبوية في جذبها في عدد من الدول، وتتراوح من 20% إلى 30% من جمهور الناخبين، لن ترقى إلى الحد المطلوب لفرض النفوذ (40% على الأقل) إذا شهدت الدول المتقدمة تدهورًا اقتصاديًا آخر. وهذه الحقيقة تجعل اضطرابات الأسواق في الآونة الأخيرة أمرًا مثيرًا للاهتمام، فلربما تنتهي حقبة ما بعد الأزمة بتحولٍ حاسم من العولمة نحو اقتصادات قومية … وإرهاصات ذلك تظهر أمامنا يومًا تِلو الآخر.
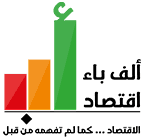

جميل جدا جزاكِ الله خيرا